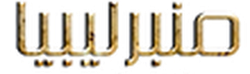تتوافر مجموعة واسعة من الدراسات حول حل النزاعات وقضايا ما بعد النزاع المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مع وجود قدر كبير من الاتفاق والإجماع بين المتخصصين حول ما يعتبرونه “أفضل الممارسات” الدولية.
يُقدم هذا المقال هذه الممارسات ويحاول تطبيقها على الحالة الليبية، ويحدد أسباب فشل محاولات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا. كما يُشير إلى وجود حاجة ماسة للنظر في مزايا المصالحة الوطنية وضرورتها إذا أُريد لليبيا أن تخرج من أزمتها المستمرة.
منذ منتصف التسعينيات فصاعدًا، أصبح نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عنصرًا أساسيًا في معادلات صنع السلام وإعادة الإعمار.
الهدف الأساسي الذي يدعم تطبيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هو منع تكرار الظروف التي قد تتفاقم إلى حرب أو تُشعل فتيلها من جديد، وتهدد النسيج الاجتماعي الذي ينشأ عادةً بشكل هش للغاية ومستقطب للغاية في أعقاب صراع داخلي و/أو حرب أهلية.
الأهداف الرئيسية لهذا النهج واضحة:
بناء الأمن وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، وتنمية القدرات البشرية في البلدان الخارجة من الصراعات، بما يُمكّن من إرساء سلام مستدام طويل الأمد. تُعتبر مبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني المُشتركة الآن لا غنى عنها لتحقيق الأمن، وللحيلولة دون تجدد أعمال العنف التي تُهدد حتمًا النسيج الاجتماعي وآفاق الانتعاش الوطني.
ومن العناصر الأساسية التي قد تضمن نجاح نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التفاوض والاتفاق على معاهدة سلام.
وهذا شرط أساسي لبدء واستمرار عملية السلام التي تتضمن إطارًا وخارطة طريق لتحقيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، على نحوٍ مقبول من جميع الأطراف المعنية.
يجب أن يكون اتفاق السلام واضحًا ومُفصّلًا بما يكفي بشأن هذه القضايا، وإلا فقد يُصبح أي سلام ناتج غير مستدام – إذ ستستمر وجهات النظر المُتباينة في الانتشار والتنازع على تفاصيل مُحددة قبل حتى إطلاق أي مبادرة من هذا القبيل.
يُعد نجاح بُعد نزع السلاح في أي اتفاق سلام بمثابة مقدمة وشرط أساسي للانتقال إلى العنصر المهم التالي المتمثل في عملية التسريح. ويكمن أحد أخطر التحديات في أي نزاع مسلح داخل الدولة أو حرب أهلية في منع إعادة التسلح. فالمقاتلون السابقون الذين لا يخضعون لبرنامج تسريح يتخلون فيه عن أسلحتهم يميلون إلى استخدامها مجددًا.
في ليبيا، تحتفظ الميليشيات القبلية والإقليمية والمدنية بمعظم الأسلحة الخطيرة والثقيلة والمتطورة، وهذه الأسلحة، على الرغم من تسييسها وإضفاء طابع قبلي عليها، قد تكون أيضًا “أوراق مساومة” ذات قيمة كبيرة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
بما أن بناء الثقة في ترتيبات المصالحة قد لا يكون شاملًا، وهو – بحكم تعريفه – عملية تدريجية، فإن العديد من الأطراف ستظل تشعر بالتهديد المحتمل، وبالتالي تلجأ إلى إخفاء الأسلحة والاحتفاظ بمخابئها لاستخدامها لاحقًا.
لذلك، قد يكون برنامج “السلاح مقابل التنمية” مناسبًا تمامًا لتشجيع هذه التشكيلات الاجتماعية على تسليم مخابئ أسلحتها مقابل منحها مخصصات مالية خاصة للتنمية المحلية أو الإقليمية.
من المؤكد أن هذا البرنامج سيمثل خطوةً نحو التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني. علاوةً على ذلك، من المرجح أن تُوفر حافزًا كافيًا لتسليم الأسلحة المخبأة. وتُشير التجربة إلى أن عدم استباق هذه الظاهرة يُهدد بعرقلة عملية نزع السلاح لاحقًا، وقد يُؤدي إلى تجدد العنف.
بالإضافة إلى وضع برامج خاصة لتحقيق هذا الهدف المتمثل في إعادة دمج الميليشيات، فإن مزامنة هذه البرامج وربطها باستراتيجية مستدامة للسلام والمصالحة يُعدّان العنصر الأساسي لنجاح عملية المصالحة الوطنية والاستقرار والتحول الديمقراطي برمتها.
عندما تُشرك شرائح كبيرة من السكان – وخاصة الشباب – في المعادلة، فإن إعادة الدمج لن تكون كافيةً لتحقيق النتائج المرجوة ما لم يُصاحبها برنامج شامل للحوار الاجتماعي والسياسي يهدف إلى تحقيق المصالحة.
في الحالات التي اندلعت فيها حرب أهلية نتيجة ثورات ضد نظام، كما في الحالة الليبية، والتي أدت إلى انقسام الشعب إلى مؤيدين ومعارضين، بالإضافة إلى استقطاب المناطق والمدن والبلدات والقبائل إلى فئات واسعة تحت مسمى “الفائزين” و“الخاسرين“، فإن إبرام معاهدة سلام ومصالحة وطنية يُعدّ أولوية قصوى .
من الضروري أن تشمل العملية إشراك جميع الأطراف دون إقصاء، سعيًا لحماية ثورة الشعب وضمان ما حققته من إنجازات ومكاسب. لذا، يجب أن تتضمن أي استراتيجية انتقالية حوارًا ومصالحة وطنيين يُوليان أهميةً مناسبةً للعدالة الانتقالية. ومن الضروري أيضًا أن تتضمن هذه الاستراتيجية عناصرَ لإنعاش الاقتصاد الوطني، وأن تُعالج مظالم جميع الفئات الاجتماعية والأقليات الضعيفة.
أدت الانتفاضة في ليبيا في النهاية إلى الانهيار التام للهياكل السياسية والأمنية والعسكرية للنظام السابق. وتعود أسباب الفوضى الحالية في ليبيا إلى التجربة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الفريدة للنظام السابق وفشلها في إقامة دولة حديثة قابلة للحياة.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي اعتبار فشل نظام القذافي مبررًا لفشل آخر في عملية بناء دولة شاملة. ويصدق هذا بشكل خاص إذا أُشركت جهات فاعلة غير رسمية، كالهياكل القبلية والجهات شبه المستقلة، بما في ذلك الجماعات المسلحة، في المشهد السياسي من خلال ترتيبات مؤسسية، لإعادة صياغة السياسة بالوسائل السلمية، والاعتراف بالتنوع الاجتماعي والسياسي للبلاد، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
على الساحة الليبية، كانت محاولة بناء السلام غير واردة، إذ ارتكزت على ترسيخ مصالح ووجهات نظر وتحيزات وامتيازات “المنتصرين” على حساب “الخاسرين“. لم يكن هناك سوى “سلام مرغوب فيه” واحد، متجانس، استبعد أي نظراء منافسين حقيقيين أو محتملين قُتل ممثلوهم أو سُجنوا أو نُفوا.
ومن ثم، استُبعد هدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل، لا سيما وأن “الثوار” المنتصرين، وهيئتهم الانتقالية، وداعميهم الأجانب، لم يتركوا مجالًا للاعتراف بقيمة الاعتراف بالعناصر المهمشة من “الجانب” الآخر، وكانوا غير مهتمين تمامًا بإشراكهم في المناقشات أو تسوية سلمية.
يثير هذا الواقع تساؤلات مثيرة للاهتمام حول سبب معارضة القوى الغربية التي أطاحت بنظام القذافي للاستنتاجات والتوصيات الصريحة للمتخصصين ومراكز الفكر التي سلطت الضوء على الأهمية القصوى لمنع ميليشيات زمن الحرب من أن تصبح أجنحة مسلحة لجبهات أو توجهات أو جماعات سياسية.
شدد إيان مارتن، أول رئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في شهادته في ديسمبر 2011 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أنه “ما لم تتم معالجة الوضع الأمني بسرعة وفعالية، فقد تترسخ مصالح مختلف أصحاب المصلحة، مما يقوض السلطة الشرعية للدولة“.
إن لم يكن لسبب سوى رفض أو نفي ادعاءات القذافي وتحذيراته المستمرة من تورط القاعدة وجهاديين ومجرمين آخرين في القتال، فقد تجاهل حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتحالفه في عملية الإطاحة به الحقائق على الأرض.
وكان لهذا أثرٌ في ترك جزء من مهام الأمن وإعادة الإعمار بعد الصراع في أيدي هذه العناصر تحديدًا – على افتراض أن السلطات الليبية المؤقتة، التي ساهمت هذه العناصر في تشكيلها، لم تكن مستعدة لقبول أي عمليات حقيقية وذات مغزى بعد الصراع، مما سهّل سيطرة الفصائل المسلحة على البلاد. وكانت نتيجة هذا الإغفال، للأسف، استمرار الأعمال العدائية وعدم الاستقرار وتجدد القتال في أجزاء كثيرة من البلاد.
إن العديد من العمليات العسكرية، التي سعت ظاهريًا إلى إخضاع ما يُسمى بالمناطق الموالية للقذافي و“ترسيخ الثورة“، لم تُسفر إلا عن مزيد من استقطاب المجتمع. وهذا يعني ضمنًا تدهورًا مستمرًا للوضع الأمني، تتفوق خلاله الميليشيات، مُحبطةً بذلك جميع محاولات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، التي ثبت في النهاية أنها سطحية.
في غضون ذلك، ازدادت الميليشيات رسوخًا في مواقعها، وتزايدت الأسلحة الفتاكة. بل ازدادت المشكلة حدةً مع عجز السلطات الانتقالية عن السيطرة على الوضع، مع استمرار تدفق الأسلحة والذخيرة إلى البلاد الخارجة عن القانون.
وقد ساهم انتشار الأسلحة، وكثرة المسلحين، واستخدامهم دون عقاب، في زعزعة استقرار البلاد، وتزايد المخاطر على حياة المواطنين، وتسبب في كثير من الحالات في تجدد الصراع الذي يهدد – أحيانًا – بالانتشار إلى الدول المجاورة.
وعلى أرض الواقع فإن إنشاء اللجنة الأمنية العليا وقوات درع ليبيا في عام 2012 كهيئتين أمنيتين وعسكريتين جديدتين لدمج المتمردين لم ينجح إلا في ضم أكثر من 200 ألف فرد إلى قوائم رواتبهما.
وكان هذا العدد – الذي كان فلكيًا بكل المقاييس – نتيجةً حتميةً لنشر ميليشيات أخرى، ضمت متطرفين، مما لم يُقدم سوى مظهرٍ واهٍ لـ“نظام أمني” جديد ناشئ. تأكدت الشكوك لاحقًا من خلال تطورات أكدتها مصادر عديدة، أكدت أن اللجنة الأمنية العليا وقوات درع ليبيا كانتا ببساطة من بين جماعات عديدة تعمل باستقلالية تامة عن سيطرة الدولة.
أما الجماعات التي أُدمجت تحت جناح اللجنة الأمنية العليا وقوات درع ليبيا كوحدات متكاملة، فقد واصلت العمل كوحدات مستقلة تمامًا كما كانت تفعل سابقًا، معززةً بذلك شرعيتها وممارسة “سلطتها” دون أي تدخل.
لم تكن الخطوات التي اتخذها المؤتمر الوطني العام أول هيئة تشريعية منتخبة عام 2012 في الواقع سوى منح الحصانة للهياكل الأمنية الهجينة والموازية التي ظهرت بعد عام 2011.
وكانت النتيجة هي: استبدال العدالة الانتقالية بعدالة المنتصر… إلى جانب قانون العزل السياسي الصادر في مايو 2013، والذي أخذ عملية التطهير والملاحقة الجنائية لأعداد كبيرة من الموظفين المدنيين والضباط المرتبطين بعهد القذافي إلى مساحات أكبر بكثير مما كانت عليه في أي دولة أخرى من دول الربيع العربي؛ وقد أدى هذا إلى رد فعل عنيف وأدى في النهاية إلى حرب أهلية.
أحد التحديات التي لا يزال يتعين التغلب عليها هو الرفض القاطع من جانب “الثوار” في حرب 2011 لأي دعوة إلى صنع السلام مع خصومهم السابقين أو مع المناطق والمدن والقبائل التي تُصنف على أنها بقايا النظام السابق.
بعد توحدها في قتالها ضد القذافي، أثبتت الجماعات المسلحة عدم استعدادها لنزع سلاحها أو تسريح عناصرها أو دمجها في صفوف الجيش أو المؤسسات الأمنية الأخرى. وحرصت بعض الجماعات على وجه الخصوص، على الحفاظ على قدراتها التنظيمية والعسكرية سليمة لتحقيق أجنداتها الخاصة.
ونتيجة لهذا الوضع، برز “توازن” عسكري وأمني غريب، حيث كانت للكتائب المسلحة اليد العليا، بينما افتقرت الدولة الناشئة إلى أي سيطرة حصرية على القوة العسكرية، واضطرت إلى الاعتماد على بعض الميليشيات لتصبح في النهاية رهينة لها ولأجنداتها المتنوعة والمستقلة.
وظهرت المؤسسات الأمنية التي شُيّدت في عهد القذافي متهالكة وفي حالة من الفوضى بعد الإطاحة به. ولكي يُعاد تأهيلها أو تُحوّل إلى هياكل قابلة للاستمرار، فإنها تتطلب اهتمامًا كافيًا في عملية شاملة للإصلاح والتحديث.
حتى الآن، أثبتت جميع محاولات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أنها سيئة التصميم والتنفيذ، على الرغم من التمويل الضخم، مما أدى للأسف إلى الفساد وإهدار الموارد العامة، مما ألحق المزيد من الضرر بالمبررات المتصورة لهذه البرامج وجاذبيتها.
بالإضافة إلى صراعاتهم الداخلية، جاءت هياكل سلطاتهم مشتتة، تفتقر إلى تسلسل قيادي واضح، وغير موثوق، وخارج نطاق سيطرة الدولة. في النهاية، لم يُلحقوا سوى الضرر بسلطتها وشرعيتها.
يمكن تفسير ذلك، جزئيًا على الأقل، بإرث القذافي الذي كان نظامه يُكنّ ازدراءً واضحًا ومُذلًا لمؤسسات الدولة النموذجية، واعتمد بدلًا من ذلك على أجهزة موازية ومنظمات شبه عسكرية وشبه حكومية. وقد افتقرت قيادة المؤسسة العسكرية للنظام السابق إلى الاحترافية، ولم تكن لديها قدرة حقيقية على التفكير والتخطيط الاستراتيجي.
وبالتالي، وفي ظل هذه الخلفية، يُثير الشك الشديد كيف يُمكن لليبيا أن تُمضي قدمًا في برامج إصلاح القطاع الأمني القابلة للتطبيق دون مساعدة المجتمع الدولي. ومع ذلك، غني عن القول إن الليبيين أنفسهم بحاجة إلى تحديد ووضع الأهداف الجوهرية لأمنهم الوطني وعقيدته. يستلزم هذا تحديد المخاطر والتهديدات المُتصوَّرة والفعلية للأمن القومي التي تُبنى عليها وظائف ومسؤوليات مؤسساتهم الأمنية.
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة راند، من المهم لأي استراتيجية لإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا أن تُحقق بعض النجاح، ومن الضروري وضع المعايير المناسبة التي تُمكِّن المخططين من التمييز بين الميليشيات التي يُمكن تسريحها سلميًا وتلك التي تحتاج إلى تطبيق “وسائل أخرى” لتحقيق نزع سلاحها وتسريحها.
ومع ذلك، تُشير التطورات التي شهدتها ليبيا في عام 2014 إلى أنه، على عكس التوقعات، فإن معظم الميليشيات ليست مستعدة أو مُهيأة للتخلي عن أسلحتها أو تسريحها وإعادة دمجها في المجتمع المدني. حتى التشريعات التي أصدرها المجلس الوطني الانتقالي، والتي تمنح عفوًا تلقائيًا عن أي أفعال سابقة وانتهاكات لحقوق الإنسان من قِبل هذه العناصر، لم تُحقق أي أثر مرغوب فيه.
________________
المصدر: دراسة للدكتور يوسف صواني بعنوان “إصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة دمج الميليشيات: تحديات بناء الدولة في ليبيا“